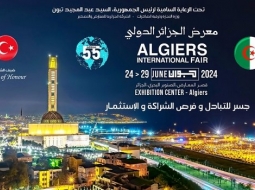ترك برس
سلّط مقال للسياسي والأكاديمي التركي، ياسين أقطاي، الضوء على كليات الشريعة الإسلامية (الإلهيات) في تركيا ودورها في الحياة الفكرية والأكاديمية.
وتساءل الكاتب عما إذا كانت "العلوم الإسلامية اليوم تفي بمهمتها في تثقيف علماء الدين الذين يحتاج إليهم المجتمع المسلم؟"
وأضاف أنه "عندما نتحدث عن علماء الدين، فنحن نقصد المعنى الحرفي لهذه الكلمة، حيث تصبح مهمتهم تعليم وتدريس العلوم والتاريخ والفقه والعقيدة الإسلامية لمجتمع يعرف الإسلام ويؤمن به ويحمل معتقداته؛ وإن كان في المستوى الأساسي، بهدف تنوير المجتمع بما يتماشى مع هذه المعرفة، وقيادته وتوجيهه عندما يحتاج إلى ذلك."
وأشار إلى أن المقال يوضّح الدور الكبير الذي يجب أن تقوم به كليات الدراسات الإسلامية في تركيا.
وفيما يلي النص الكامل للمقال:
كليات العلوم الإسلامية في تركيا هي مركز للنشاط الأكاديمي، ونادرًا ما تتمكن من تقديم ما هو مُتوقع منها من تخريج علماء دين حقيقيين، ولذا فإن التساؤل هو: ما جوهرها؟ وما إطارها؟
في عام 1993 كنت أحاول العثور على إجابات لهذه الأسئلة في أطروحة الماجستير الخاصة بي بعنوان "مناقشات فكرية وسياسية حول إضفاء الطابع الأكاديمي على المعرفة الدينية"، التي أكملتها تحت إشراف الأستاذ الدكتور بهاتين أكشيت، وكدراسة ميدانية لرسالتي التي أقوم بها؛ كنت في كلية العلوم الإسلامية بجامعة أنقرة أقوم بداسة لتاريخ تأسيسها وعملها الحالي.
هناك اختلاف كبير بين المعرفة الدينية الأكاديمية والمعرفة الدينية التي يتبعها الاستيعاب والتطبيق، بمعنى أن انتقال المعرفة الدينية من حيز المعرفة المجردة للدارس إلى حيز استيعابها والقدرة على إيصالها إلى الآخر يحتاج إلى جهد كبير وعمل دؤوب لضمان حدوث ذلك، بل قد لا يحدث هذا الانتقال بالضرورة للجميع، ولكنّ هناك فرقا واضحا بين مهمة المعرفة الأكاديمية ومعرفة الشخص الذي يؤمن بدينٍ ما ويأخذ معرفة ذلك الدين كأمر أو شعار وتطبيق ونقل.
وهو فرق بين موقف من يقرأ القرآن فقط في الصلاة، بقراءة كل حرف فيه على أنه كلمة الله الثابتة غير المتغيرة وأنه رسالة حية موجهة إليه يعمل على تطبيقها في حياته، ومن يقرؤه كأي نص عادي ويقوم بإجراء جميع أنواع التحليلات عليه.
إن الأشخاص الذين يقرؤون نص القرآن ويؤمنون به بهذه الطريقة الثانية لديهم العديد من القراءات الأكاديمية التي اكتشفت الأبعاد الدلالية والخصائص اللغوية والخطابية والعلاقات النصية والميزات التي لا يدركها الأشخاص الذين يقرؤون نص القرآن بالطرق العادية، وهي أيضًا دراسات تستحق أن تُدرج في علوم القرآن بطريقة ما، وعلاوة على ذلك؛ أجريت بعض هذه الدراسات من قبل أشخاص لا يصدقون أن القرآن هو كلام الله.
القرآن موجود في أيدي البشرية جمعاء، وهو مفتوح للجميع للقراءة والدراسة، وسوف يفهمه بعض الناس بهذه الطريقة، ويفهمه آخرون بطريقة مختلفة، وسيقرؤه بعض منهم بإيمان، وسيقرؤه غيرهم من دون تصديق وبإنكار؛ تبعًا لمعتقداتهم السابقة.
ندرك من ذلك أن الخلاف الذي يحدث بين المسلمين نتيجة لقراءتهم كلام المستشرقين عن القرآن وتفسيره لا أجده يتسم بالمنطق، وهو مشكلة خطيرة، فما الذي يمكن توقعه من شخص لا يؤمن أصلًا بهذا الدين حين يقوم بقراءة القرآن وتحليله؟ ما شكل الاستنتاجات التي يمكن أن يصل إليها؟ لذلك أجدها من الأشياء التي ربما يطلع عليها المسلم وهو يلبس قبعة الأكاديمي لكن لا ينبغي بناء تصورات عليها ومجادلات طبقًا لها لأن على المسلم أن يرى القرآن ويقرأه من منظور ديني روحاني وليس من وجهة نظر أكاديمية بحته.
في عالم اليوم تزداد الاتصالات كثافة بين الطوائف والثقافات ونواجه هذه الاختلافات بشكل مكثف كل يوم، وعندما يتصور المجتمع أن محاولة فهم هذا الاختلاف والتعامل معه ومجابهته بالحجة والدليل والمعرفة على أنه خيانة للمعتقدات الدينية، فالأمر يستحق مزيدا من بذل الجهد لتوضيح هذه المفاهيم وأنها مهمة رئيسة لعلماء الدين.
وبالعودة إلى الشق الأكاديمي من العمل، فإن الأكاديمي المؤمن يجسّد هذا الجسم المعرفي من أجل القيام بدراسة أكاديمية لدين يؤمن به، أي من المتوقع أن يكون قادرا على القيام بهذه المقاربة الصعبة، أن يكون قادرا على تطبيق الطريقة العلمية الأكاديمية في البحث العلمي من دون أن يخلع عن نفسه عباءة الدين الذي يؤمن به، ولكن إلى أي مدى يمكنه تنفيذ ذلك؟
هناك؛ في كليات الشريعة الإسلامية تبدأ العملية الأكاديمية للمعرفة الدينية مع الشعور بكل الصعوبات التي تواجهها، وبينما يحاولون الحفاظ على هذه المقاربة بين النظرة الأكاديمية والنظرة الدينية، يذهب بعضهم إلى اعتبار أنفسهم منفصلين عن هذا التصور، وبعضهم يرى تحيزاته وتفسيراته السابقة كجزء من الإلهام، حتى من دون أن يدرك عواقب هذا التفسير، وسيرى الاعتراض على تفسيره على أنه اعتراض على الدين، وردة فعله ستكون بِلُغَة دينية بحتة.
وإذا استمرت هذه الحالة من عدم التمييز الدقيق بين اللغة الأكاديمية واللغة الدينية على هذا النحو، فسيأتي يوم لن نكون قادرين فيه على التمييز بينهما، وهذا الأمر قد يتكرر في كل مستوى من مستويات الدراسة الأكاديمية، تحت ستار اللغة غير الدينية "العلمية".
وسلسلة الممارسات هذه -التي لاحظها المؤرخ وفيلسوف العلم الشهير بول ك. فييرابند في كتابه "كنيسة العلم"- ليست سوى إضفاء الطابع الديني على العلم، وحقيقة أن التطور قد وجد مكانه كمسألة إيمان وليس موضوعًا للعلم هي مثال ممتاز على هذا، وهذا ليس موضوعنا الآن.
موضوعنا اليوم هو ما نتوقعه من كليات العلوم الإسلامية، من أكاديمييها وخرّيجيها، أو بكلمات أخرى: ماذا نتوقع من عالم الدين المتخرج في هذا الصرح العظيم؟ هل نتوقع منه أن يعلمنا الإيمان وممارسة الدين؟ وإذا كان لدينا مثل هذا التوقع، فهل نحن جاهزون لتقبل إرشادات هذا المعلم ونصائحه؟
عندما يكشف عالم الدين بأبحاثه وتحقيقاته أن ما نعرفه من الدين قد أصبح تدريجيًّا عبارةً عن تفسيراتنا التاريخية الخاصة أو أصبح مصابًا بالابتكارات والخرافات، فإن ردود الفعل المعارضة التي يواجهها تُظهر أن المجتمع ليس فارغًا أيضًا، وفي هذه المرحلة تصبح العلاقة بين عالم الدين وجماعته قضية خطيرة تستحق الالتفات إليها والوقوف عندها.
ورغم أن عالم الدين يحتاج إلى إدراك أن الجماعة تنتظر معلمًا لهم للقرآن، فإنه في ما يخص الوفاء بالواجب الذي يتوقعه الشعب المسلم من عالم الدين، هناك رسالتان أكثر أهمية يجب أن يشعر عالم الدين بثقلهما:
أولًا: تاريخ كليات العلوم الإسلامية في تركيا وتعريف المهمة المفروضة عليها، إذ تعمل اليوم بشكل مختلف كثيرًا عن الرؤية والتوقع.
ثانيًا: مهمتها كمؤسسة علمية في إطار جامعة أن يُطبق فيها نموذج العلم الإيجابي الذي يُسفر عن تطور فكري وديني حقيقي.
ومن الواضح أن كليات العلوم الدينية اليوم تقف في مرحلة مختلفة تمامًا عن هذه المهمة؛ ليس فقط في تركيا ولكن أيضًا في العالمين المسيحي واليهودي. وقبل أن أتوقع أي شيء من عالم الدين، يجب أن تكون هناك المناهج والسبل في تلك الكليات التي تؤهله للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه، وهذا وحده ما سيجعل هذه الكليات محافظة على بنائها ومكانتها ودورها الذي يتوقع دائمًا أن تقوم به، والذي بدوره سيضمن الحفاظ على التماسك الديني للمجتمع حتى عند الخلاف.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!